كُتيِّبٌ للمفرداتِ لا الجُمَلْ وفيه ما يعصِمُكم من الزَّلَلْ وفيهِ شرحٌ لِكلامٍ قد نزَلْ على النبيِّ المصطَفى
ولم يَزَلْ يَتْلُوهُ كلُّ مَن سعى أو اعتَزَلْ فاتِحَةُ الكتابِ أَلْفُ خَطَأِ شَاعتْ،
ومن منَّا الذي لم يُخطِئِ لم أَذكُرِ الغريبَ كالـمُحْبَنْطِئِ لكنْ فَصَلْتُ مَوطِئاً عن مَوْطِئِ شَتَّانَ بين خَاطِئٍ ومُخْطِئِ
ثم أَتيتُ بالصَّوابِ والصَّوابْ فَلِلسُّؤالِ غالباً غيرُ جَوابْ مَنْ خَطَّأَ الناسَ ولَجَّ في العِتابْ
فحقُّه أن يَرعَوِي ويُسْتَتابْ لا تَدَّعِ العِصمَةَ أو فَصْلَ الخِطابْ وقد رأيتُ في كلامِ الناسْ ما يرفِدُ الفُصحَى بلا التباسْ
واللهِ قَدْ فقُلْ لِمَنْ على القَديم قدْ رَقَدْ لا يَفقِسُ البيضُ إذا البيضُ فَسَدْ
عارف حجّاوي.. ذلك المارد الذي خرج من القمقم! أين كان؟ وكيف اختفى عنّا طوال هذه السنين؟
يبدو أنّه كان غارقا حتى أذنيه في غمار عمله المتمترس حول النصّ، ومن هذه النقطة تماما تكمن أهمية الرجل.
كنت قد سمعت به وشاهدته في العام الماضي في بعض المقاطع، ولكني لم أتمعّن جيّدا في ما يكتب ويحكي إلا مؤخرا،
وأعجبت بطرحه إعجابًا كبيرا، ووجدتُني أتفق معه بشكل كبير، ليس في أنني أشترك معه في الأصول النابلسية،
ولا أنّني أحبّ مثله الخطّ الفارسي،
بل اتفقت مع الأستاذ في طرحه المتعلّق بالعربية؛ كيف نتعلّمها؟ ما الذي ينبغي تجاوزه؟
موقفه من الدرس النحوي التقليدي، وما يدور حول ذلك.
لقد تنبّهتُ إلى قيمة الأستاذ عارف حجاوي حين تابعتُ بعض لقاءاته الأخيرة وتحدّث عن جملة أشياء منها رأيه بعلم النحو،
فما زلتُ من الداعين إلى تيسيره وإلى عدم تدريس الطلبة تفاصيله الوعرة،
بل الاقتصار على زبدته وما يدفع إلى القراءة السليمة والكتابة السليمة والفهم السليم.
وهذا هو ما يدعو إليه الأستاذ عارف تماما. في الواقع، لا أعتقد أن أحدا يدرك قيمة ما يفعله عارف حجاوي مثلي،
فما زلت من المشتغلين بالنصّ العربيّ دراسةً وكتابةً وترجمةً وتنقيحًا منذ أكثر من عقد،
وأدركتُ تماما أنّ خير وسيلة لتعلّم العربية هي “معايشة نصوصها”.
فكيف برجل سبقني بعقودٍ عمل فيها منقّحا ومترجما ومحرّرا في مؤسسات مرموقةٍ
مثل البي بي سي والجزيرة وغيرها؟ لا شكّ أنه يملك من الخبرة العملية مع النصّ العربيّ ما يجعله أهلا للنصح ولأخذ الدروس منه.
وقد كتب الرجل كتابه “زبدة النحو”
وهو كتيّب صغير يلخّص فيه قواعد النحو ويقدّمها بشكل عملي ميسّر
مع أمثلة من النصوص المتداولة لكل من يحتاجها من طلبة وإعلاميين وغيرهم،
إلى جانب كتاب “اللغة العالية”
الذي هو بمنزلة معجم صنعه للإعلاميين، جمع فيه المفردات التي يحتاجونها والتي يكثر تداولها.
والخلاصة أنّ الرجل عمليٌّ واقعيّ، خرجَ من مصانع التحرير والتدقيق حتى عافها،
فهو خبرة مهنيّة متحركة، وحين يضع مثلُه كتابا في النحو واللغة
فسيختلف طرحه بشكل كبير عن المتخصصين الذين قضوا حياتهم بين جدران النظرية،
دون أن يمتطوا صهوة اللغة الحيّة وهي تتراكض في مسارات الواقع!
وحتى تعلم يأهمية الموضوع بالنسبة لي، فعليك أن تدرك تماما أنني أنظر إلى هذا الرجل بمنزلة “المنقذ”
الذي أعوّل عليه وعلى أمثاله كثيرا في الرفع من قيمة العربية في حسّ أجيالنا الحالية والقادمة.
لقد وجدت الأستاذ عارف حجّاوي هو النموذج الذي تتمثّل به هذه المبادئ قبل أن أعيَها وأعتنقها،
وتعجّبت كيف لم أعثر في الرجل قبل ذلك! ولكني وجدته ولله الحمد والمنّة.
وحتى تدرك أيّها القارئ قيمة الرجل فسأقدّم لك هنا أهم المفاتيح التي تعرّفك بجهوده في رفع راية العربية:
أولا: إدراكه للخلل الكامن في الدرس النحوي التقليدي، وهذا ليس أمرًا بدهيا،
فقد حسبتُني سأموت قبل أن أجد أستاذا قديرا يدرك أن الدرس النحوي التقليدي لا يساهم في تعلّم العربية لغةً للحديث والتداول إلا قليلا.
ثم إنّه قدّم البديل النظري المعين على إتقان قواعد العربية عند الحديث والكتابة،
وتحديدا من خلال كتابه “زبدة النحو”، وأحسبه زاد من اختصاره في كتّيب أصغر يضعه في جيب بنطاله!
ثانيا: تقديمه لحدائق وارفة من النصوص العربية بصوته الفصيح الأجش،
وهو تطبيق عمليّ لما يؤمن به من أنّ العربية يجب أن تُدرس من خلال النصّ الجميل، أن تُقرأ شعرا وقصّة.
وقد أضاف إلى ذلك موسوعته الجميلة في الشعر العربي،
والتي تضمّ مجلّدات كبيرة عرّف فيها بأبرز شعراء كل مرحلة من مراحل الشعر العربي، من الجاهلية حتى الشعر المعاصر،
ثم وضع قصائدهم مشكولةً، وشرحها شرحًا مشكولًا. وهو شرح معاصر بلغة معاصرة تشدّ العقول والقلوب،
وتستهدف مواضع الجمال، ولا تنفّر الأجيال المعاصرة أو تُشعرهم بوعورة اللغة.
فهذه الموسوعة زادٌ مهم جدا لكل طالب للعربية، ليرشف نصوصها رشفًا، فتصير العربية حبّا ينبض في قلبه
قبل أن تكون قواعد يكابد حفظ تعقيداتها!
وأسماء كتب هذه المجموعة هي: “أول الشعر”، “تجدُّد الشعر”، “تألُّق الشعر”، “إحياء الشعر” و”آخر الشعر”.
ثالثا: يهتم الأستاذ عارف بمعاصرة اللغة، أي ألا نتكلّف الحديث بلغة الجاحظ والأصمعي،
فلكل عصر مفرداتٌ تطفو وأخرى تغيب في الأعماق، وكلها مفردات عربية جارية على قواعد نحوها وصرفها ومستقاة من أصولها المعجمية،
فليست الفصاحة أن تتحدّث بلغة الجاحظ، ولا حتى بلغة الرافعي أو محمود شاكر،
بل الفصاحة أن توصل خطابك من خلال اللغة بأيسر السبل وأوضحها. كما أنّ جهوده المعجمية لا تخفى،
وكتابه “اللغة العالية” مفتاح في هذا الباب.
رابعا: الأستاذ عارف من دعاة تدريس كل العلوم بالعربية،
يقول: “لا بدّ لنا من العلم، ولا بدّ لهذا العلم من أن يأتينا محمولا على ظهر اللغة العربية”.
وله جهود طيّبة في تعريب بعض الاصطلاحات المعاصرة.
خامسا: يرى الأستاذ عارف أنّ هذه الأمة لن تنهض إلا على أكتاف لغتها،
ويرى أنّ الأصل هو تعلّم اللغة العربية والقراءة بها كثيرا لاكتساب ثقافة راسخة،
ثم ننطلق بعد ذلك – أو بموازاة ذلك – لتعلّم اللغات الأجنبية. فهناك مشكلة لدى من يتعلّمون اللغات الأجنبية
مع قدر قليل من الثقافة ومن اللغة العربية كما يقول؛ لأنهم حينئذ سيعرفون قشور القشور من اللغة الأجنبية وثقافتها حين يدرسونها.
سادسا: للأستاذ عارف حرص على النطق السليم والكتابة السليمة بالعربية،
متجاوزا مجرد التدقيق على قواعد النحو والصرف، فهو يتطرق إلى العبارات الركيكة مصوّبا،
وقد استفاد في ذلك من خبرته الصحفية الطويلة في معالجة النصوص،
ومن اطلاعه الواسع على التراكيب الإنجليزية التي لاحظ تأثّرنا ببعضها سلبا من خلال الترجمة الحرفية.
هذه نقاط ستّ محورية في طرح الرجل المتعلّق بالعربية، لا أقول إنها تلخص آراءه في العربية،
ولكني أجدها من أهم ما طرحه، وهي بمنزلة المفاتيح للدخول إلى عالم العربية عند الرجل، ولإدراك قيمته من جهة أخرى.
رغم هذا التوافق الكبير مع الأستاذ عارف حجاوي، فقد اختلفت معه في رأيه بخصوص إلغاء التشكيل.
فالأستاذ عارف رغم أنه كتب ما يرشد إلى إتقان التشكيل، فإنّه يرى أنّ التمسّك بالتشكيل مستقبلا هو نزعة “سلفية”،
وأننا لا بدّ أن نتجاوز يومًا ما التشكيلَ لنُسكّنَ أواخرَ الكلمِ، فنذلّل بذلك – كما يرى – صعوبة تقف عقبة أمام طلاب العربية.
ويرى الأستاذ عارف أنّ إلغاء التشكيل لا يؤثّر في تغيير المعنى،
وأنّ السياق هو الذي يجعلنا نعرف المعنى.
وقد ضرب لذلك مثالا في كتابه “زبدة النحو”، إذ وضع أسطرا قليلة سكّن فيها أواخر الكلم وألغى التشكيل،
ليدلل على أنّنا فهمنا المعنى رغم إلغاء التشكيل!
وفي نظري، وليسمحْ لي الأستاذ عارف بأن أناقشه رغم فارق الخبرة والعلم والسنّ،
فليس صحيحا أنّ إلغاء التشكيل لا يؤثّر في تغيير المعنى، حتى لو قلنا إنّ السياق يوضح المقصود،
فإنّ البشر عقول متفاوتة وقد يحدث الاختلاف كثيرا رغم وضوح السياق كما يبدو لأول وهلة،
ولهذا يأتي التشكيل كضابط مهم لتحديد المعنى. وفضلا عن ذلك، فإنّنا حين قرأنا الأسطر المسكّنة في كتاب “زبدة النحو”
كنا نحسن قراءتها لرسوخ آلية النحو في أدمغتنا بعد التمرّس بها لسنوات.
ثم إنّ هذه الأسطر لا تمثّل جميع أنواع الجمل وجميع المفردات، فأحيانا قد ترد جملة فيها إشكال: هل هذه الكلمة فاعل أم مفعول به؟
وقد يكون الخياران محتملين في السياق، فهنا يأتي الإعراب أو التشكيل ليضبط المعنى.
فضلا عن ذلك، فإنّ إلغاء الإعراب سيمسّ ولا شكّ في فهمنا للنصّ القرآني، وهو الأخطر،
ثم في حفاظنا على تراثنا الشعري القديم بكامل ألقه، جرّب أن تقرأ قصيدة لامرئ القيس بغير إعراب
وانظر كم ستخسر! إنّ التشكيل أو الإعراب في نظري جزءٌ من منطق العربية المتكامل،
عضوٌ من أعضائها لا يمكن فصله عن جسدها،
ونحن إذا فصلناه سنجد صعوبة في التواصل مع تراثنا العربي العتيد، بدءًا بالقرآن الكريم ثم السنّة النبوية ثم الشعر العربي.
أما مشكلة عدم القدرة على الإعراب خلال القراءة عند المعاصرين
فهي ليست أنّ الإعراب لا يكون إلا بتصنّع، بل هي مشكلة حضارية في المقام الأول،
وها هي الإنجليزية احتوت على الكثير من الكلمات المكتوبة بإملاء لا يعبّر عن المنطوق،
ولا يمكن الزعم بأنها تنسجم مع السليقة، ومع ذلك لم تُلغ حتى يومنا هذا.
وها هم الإنجليز وسائر شعوب الأرض يتعلّمون الإنجليزية ويتعاملون معها لغةً للعلوم ولا يشْكون من هذه الطريقة العجيبة في كتابة الكثير من الكلمات. وذلك لأنّ للإنجليزية من القوة الحضارية التي تجعل الشغف بتعلّمها والإصرار على ذلك متجاوزا لصعوباتها وعراقيلها البنيوية، بل تصبح هذه العراقيل الصعبة مما يتسابق عليه دارسوها، ويتفنّنون في لملمة شواردها وإتقانها.
ورغم هذا الاختلاف،
أجد الأستاذ عارف ما زال ماضيًا مع ما يسمّيه “الفكر السلفي”، معتنيًا بالتشكيل في كلامه ومدرّسا له،
بل يرفده بكل ما يعين على تذليله أمام الطلبة، فهذا ما جعلني أدعو إلى إدمان الاستماع للرجل والقراءة له،
وهو عندي من أهم الدعاة إلى الفخر بالعربية ومن أهم المدافعين عنها والعاملين على إبقائها لغةً حيّة.
مع أنّي لا أحب أن يسمّى الحفاظ على التشكيل فكرا “سلفيّا”؛
لاعتقادي بأنّ التشكيل جزء من فلسفة العربية وسرّها الخالد
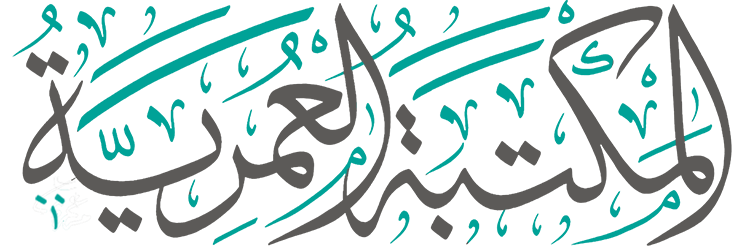

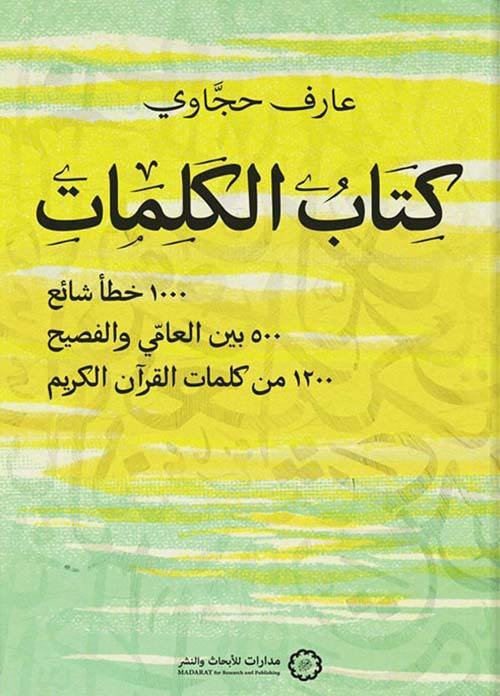
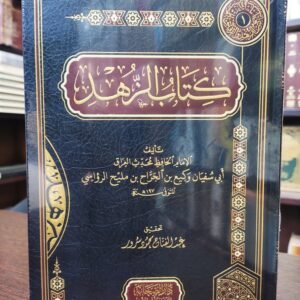
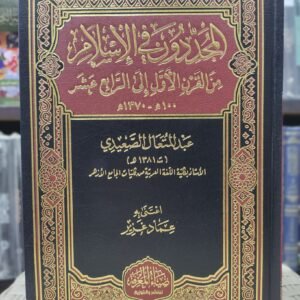
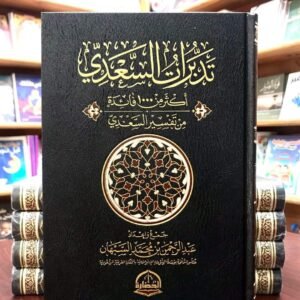
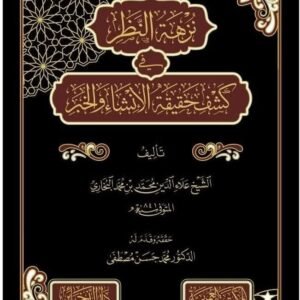





المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.