جمهرة المقالات ..عباس العقاد {7}
جمعها وقابلها على أصولها : عبدالرزاق عيسى
مدارات للأبحاث والنشر
هذا هو المجلدُ السابع من جمهرة المقالات
وهو امتدادٌ لأربعة المجلدات السابقة المعنونة بـ «في رحاب الأدب والنقد».
وإنك واجدٌ في هذا المجموع ما وجدتَه في سوابقه وما ستجده في لواحقه
من تنوُّع بديع ينبيك عن موسوعية العقاد المُعْجِزة التي لا نكاد نقف على نظير لها بين كُتَّاب القرن العشرين وناثريه
على كثرتهم وعلى اختلاف حظوظهم من سعة العِلْم والإحاطة بألوان الفنون والمعارف.
وفي الحق أن القراءة للعقاد في العموم وقراءة جمهرة مقالاته على وجه الخصوص
تعلِّم العقل والأدب جميعًا؛
إذ جمعت كتابتُه -كما يقرر الأستاذ محمد أبو زهرة،
الشيخ المـُعَمَّم الذي فُتِن بالعقاد- بين عمق التفكير وجمال التعبير؛
فإنك إذا قرأتَ له قرأتَ لعالم كبير يربط بين المعاني ربطًا مُحْكَمًا بحيث يأخذ بعضُها بحُجُز بعض،
وفي الوقت نفسه ترى صورًا بيانية رائعة فتحس بجمال التعبير يعلو حتى تظن أن دقة التفكير قد توارت،
ولكن سرعان ما تتكشَّفُ لك من بعد رُواء اللفظ المعاني الأبكارُ.
ويستطرد أبو زهرة
في وصف العقاد مبيِّنًا خلائقه النفسية التي لا تقل أهميةً عندنا عن خصائصه الفكرية والأسلوبية؛
إذ يقول:
«لقد كان العقادُ مستقيمَ النَّفْس والفكر والخُلُق استقامةَ قامته المديدة، وكان يكتب لنفسه،
ولا يكتب لغيره، فهو لا يكتب لإرضاء هوى الناس، أو رجاء مثوبةٍ من الناس، ولكنه يكتب ما يراه الحق،
وما يعتقد أن فيه نفعًا للناس، لا يُهمه غضبُ الغاضبين، ولا مسايرةُ الحاكمين،
ولكن يُهمه أن يكتب ما يكون استجابةً لضميره الذي بين جنبيه،
وقد تحمَّل آلام السجن، والتقتير عليه في الرزق في سبيل ذلك،
ولم يتحول من اليمين إلى الشمال، ولا من الشمال إلى اليمين،
بل سار في خَطٍّ مستقيمٍ لا عوج فيه ولا التواء».
***
وينتظم هذا المجلدُ
طائفة من المقالات المتنوعة في الأدب واللغة والسياسة والتاريخ والفكر والاجتماع… إلخ.
وإنك لا تخطئ فيها -على كثرتها وتنوعها-
أسلوب العقاد في حُسْن إحاطته بالمادة التي يكتب فيها، ودقة منهجه في تناولها،
وصرامة نقده لما يستحق النقد منها، وجمال بيانه في صياغة ما يريد الإفصاح عنه من نظرات وآراء تجلِّي لنا وجهَ الحق فيها.
فمن القضايا الأدبية التي تناولها الأستاذُ العقاد بالحديث
قضية «الأدب والإصلاح»،
التي تُعَدُّ واحدة من أعقد المشكلات الأدبية التي واجهت النقاد المعاصرين،
وقد انتهى فيها العقادُ إلى رأي متوازن خلاصتُهُ
أن الأديب لا يَغُضُّ من أدبه أن يكتب في مسائل الاجتماع والإصلاح الموقوت،
ولكن الكتابة في هذه المسائل ليست شرطًا من شروط الأدب،
وليست حتمًا لزامًا على كل أديبٍ؛ لأن الأدبَ هو التعبيرُ، والتعبير غاية مقصودة، وغاية كافية،
وغاية لا يَعيبها أن تنفصل عن سائر الغايات.
ومن هذا الباب أيضًا
مقالُ «احتكار الأدب»
الذي فنَّد فيه العقادُ دعوى بعض المتأدِّبين الناشئين من أن شيوخ الأدباء يحتكرون ميدان الأدب،
وأنهم لا يبذلون جهدًا يُذكر في تسديد خُطى الكُتاب الناشئين.
وكان للأدب الروائي نصيبٌ من مقالات هذا المجلد؛
كمقال «القصة العلمية»
الذي شرح فيه العقاد المقصود بهذا اللون من القصص،
وألمَّ بشيء من تاريخها في الأدب العربي والآداب الأوربية
، وبيَّن مزاياها وعيوبها، وأشار إلى ما تهيأ لها من رواج عظيم بعد الحرب العالمية الأولى،
ثم ضرب لها مثلًا رواية 1984 لجورج أورويل،
وقصة «بعد غد» لروبرت هينلين، وأفاض القول فيهما.
وأفرد العقادُ أيضًا مقالة
لقصة «الحب الضائع» لطه حسين،
ممهِّدًا لحديثه عنها
بالإشارة إلى أدب المذكرات الذي شاع بين القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر
في طائفة المثقفين من أهل فرنسا، وناقش الأسباب التي تفسِّر هذا الشيوع.
ومن حديث الأدب
في هذا المجلد أيضًا
المقالُ الذي دبجه العقادُ في
تحية الشاعر الهندي الكبير تاجور،
فوصفه بأنه من ضيوف هذه الأرض المُؤنِسي
ن؛ إذ ينظر إليه الناسُ بينهم فيستحضرون الرِّضوان والأمان،
كما تنظر الأُسرةُ إلى الأب الوقور بينها فتطمئن ولا تخشى،
وإن لم يكن في يديه سلاح،
ولم يكن للسلاح غنى إن كان في يديه. ثم شفع هذا المقال
بمقال آخر عنونه بـ «السنويات الأدبية»
أجاب فيه عمن سأله عن المقصود بالسنوية التاجورية التي سبق أن أومأ إليها في تحيته إلى الشاعر الكبير.
وكان للمباحث اللغوية
حظٌّ معلومٌ من مقالات هذا المجلد،
كمقال «قِدَم الكتابة بالعربية»،
ومقال «أي اللغات أقدم؟»،
وقد عرض فيهما لأصالة العربية، وألمَّ بطرف من تاريخها الضارب في القدم،
مقارنًا بينها وبين سائر اللغات.
وثمة أيضًا مقال «الحروف العربية أصلح الحروف لكتابة اللغات»
الذي قرَّر فيه أن الحروف العربية أصلح من الحروف اللاتينية أضعافًا مضاعفة لكتابة الألفاظ والأصوات؛
لأنها تؤدي من أنواع الكتابة ما لم يُعهد من قبل في لغة من لغات الحضارة.
ومقال «اللغة العربية بين لغات الحضارة العصرية»
الذي حاول أن يبيِّن فيه مكان اللغة العربية بين اللغات الشائعة في العالم،
بالحُجة القاطعة والبرهان المُبين والمعيار الصادق الذي استمده من علم اللغات الحديث.
وتحت هذا الباب أيضًا
مقال «حرب اللغة»
الذي تحدَّث فيه عن قضية اللغة الفصحى واللغة العامية،
ومعلومٌ أن البحث في هذه القضية يتجدَّد كما يتجدَّد عادة في كل موضوعٍ باقٍ لا يقبل الفصل دفعة واحدة.
ومقال «في اللغة»
الذي تكلَّم فيه عن الفيلسوف المسلم العظيم ابن سينا من زاوية معرفته باللغة،
ومقامه في العلم بها، مبيِّنًا أثر ذلك في أسلوبه في الكتابة التي جمعت بين دقة الأداء وإيثار القصد في اللفظ والمعنى.
ومقال «العامية والفقر»
الذي ناقش فيه العلاقة بين الفقر واستعمال العامية،
وهل من دواعي العطف على الفقير أو من دواعي النظر في مشكلة الفقر أن ننصر العامية على الفصحى،
وأن نعبِّر عن آرائنا باللغة التي يتكلمها الفقراء؟
ويشتمل هذا المجلدُ أيضًا على عدد غير قليل من المقالات التي تطرَّق فيها العقادُ
إلى مباحث السياسة وأحوال الساسة؛
كمقال «الباحثون والساسة»
الذي تناول فيه بالبحث والمقارنة حظوظ رجال السياسة في الشرق والغرب من الثقافة،
والاشتغال بالعلم، والمشاركة في موضوعات الذوق أو التفكير.
ومقال «حديقة الأفكار: الرجل السياسي»
الذي رام فيه اكتناه حقيقة رجل السياسة، وتغيُّر النظرة إليه عبر العصور منذ عصر اليونان مرورًا بالعصر الوسيط
وانتهاءً بالعصر الحديث.
ومقال «الشيوخ والسياسة»
الذي تحدَّث فيه عن مزايا وعيوب اشتغال الشيوخ بالسياسة، مقارنًا بينهم وبين الشباب.
ومقال «الوعي السياسي في البلاد العربية»
الذي شرح فيه معنى الوعي السياسي، وبيَّن أنواعه، وألم بتاريخه.
ومقال «هل السياسيون منافقون؟»
الذي انتهى فيه إلى أن نصيب السياسيين من النفاق
على قدر نصيب الشعوب التي يحكمونها من الجهل والغفلة
وإيثار المصلحة العاجلة وقِلة الخبرة بمعترك السياسة الشعبية،
وأن النفاق لا يمتنع في الشعوب بمجرد اليقظة والارتقاء.
وقرر أيضًا أن الأمة الذكية قد تسمح لساستها بشيء من الكذِب والمراوغة،
إذا كانت سياسة الدولة نفسها سياسة ذات وجهين مختلفين:
وجه مسفر في العلن، ووجه مستتر في الخفاء،
وكانت مصالحها التي يفطن لها الشعب بالبداهة مرهونة بمداراة الحقائق وتلبيس الوقائع على الآخرين
. ولكن الأمم الذكية في هذه الحالة تَعزل السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية،
وتقيس كلًّا منهما بمقياس تتواضع عليه، بل تحسب الخدعة في السياسة
كالخدعة في الحرب من دواعي الإكبار والإعجاب،
ولا ترى تناقضًا بينها وبين شمائل الرجل العظيم».
ومن هذا الباب أيضًا حديثه البديع عن
علاقة الضحك والفكاهة بالاستبداد السياسي،
وذلك في مقاله الموسوم بـ«ضحك كالبكى»،
حيث أشار إلى أن الضحك في صورته الجسدية تنفيس عن الجسد المكظوم،
وأما من الوجهة النفسية، أو من الوجهة الفكرية،
فهو تنفيس عن النفس المكظومة، أو الفكر المكظوم،
وهو تعويض للحرية الضائعة، والطلاقة المحدودة،
ولهذا تكثُر الحاجة إليه في أيام الاستبداد،
ولهذا تشتهر الأمم التي طالت فيها عهود الاستبداد بكثرة التنكيت،
وشيوع النوادر المضحكة بين أبنائها.
وربما كان هذا مرجع الشهرة التي اشتهر بها المِصريون في طَوال العصور الغابرة،
حين كانوا يُبتَلَوْن بالدولة الطاغية بعد الدولة الطاغية،
تنالهم بالعَسْف والجَوْر، وينالونها بالنِّكات والنوادر،
فإذا هم يلوذون من الضحك بدرعٍ تُعينهم على الصبر وسلاحٍ يعينهم على الانتقام.
وثمة أيضًا مقالُه «الفرد والدولة»
الذي أشار فيه إلى أهمية العوامل الاقتصادية في توجيه حياة الأفراد في المجتمع،
وفي إقامة النظم الحكومية والآداب العرفية بين أهله،
ولكنه أنكر كل الإنكار ما يقوله الشيوعيون وغلاة الاشتراكيين من أن هذه العوامل هي كل شيء،
إذ لا ريب أن الأحوال الاقتصادية لها سلطان على المجتمع،
ولكنها ليست بكل سلطان في المجتمع، وليس المجتمع مع ذلك بالقضاء الذي لا يُرَدُّ له حُكْم في حياة الأفراد،
فقد يكون للأفراد حكم نافذ في كل مجتمع نشأوا فيه.
والقول بهذا كما يقرر العقاد
هو الحد الفاصل بيننا وبين دعاة الاشتراكية الذين يُلغُون سلطان الفرد ليثبتوا سلطان المجتمع،
ثم يقيمون للمجتمع قانونًا لا فكاك منه ولا محيد عنه،
وهو قانون الضرورة المادية أو الضرورة الاقتصادية، أو ما يسمونه في الجملة بالتفسير المادي للتاريخ.
وكان لمباحث التاريخ أيضًا حضورها في هذا المجلد،
وإن بدا فاترًا واهنًا خلافًا للمجلدات الأخرى.
ومن المقالات القليلة التي تجسِّد هذا الحضور
مقال «الشعوبية»
الذي ذكر فيه أن الشعوبية حالة عامة ليست مخصوصة بأمة من الأمم؛
فلكل زمن شعوبية تناسب الأُمة التي تسود فيه،
وهي تنشأ كلما نشأت في العالم أُمة لها دعوى تَنْفَسها عليها الأمم التي تحيط بها،
وتقابلها بدعاوَى أخرى من عندها،
كل على حسب تاريخها ونظرتها إلى نفسها.
فكانت في العالم «شعوبية» قبل أن تكون فيه دولة عربية،
وأصبحت فيه «شعوبية» بعد أن ضعُفت هذه الدولة وخرج عليها الخاضعون لسلطانها.
وفي هذا الإطار،
تعقَّب العقاد الأدوار التي مرت بها الشعوبية العربية منذ نشأتها الأولى إلى تاريخها المتأخر في العصر الحديث.
ويضم هذا المجلدُ -بالإضافة إلى ما أسلفنا-
أبوابًا متفرقات من الحديث في الفن والفلسفة والتأملات العقلية وشئون الفكر والاجتماع،
فضلًا عن إجابات العقاد على تساؤلات القراء واستفساراتهم،
ومساجلاته مع نفر من الكُتَّاب والمفكرين،
وغير ذلك مما نقطع بأن القراء سيجدون فيه لذة عقلية وزادًا أدبيًّا مطبوعًا بطابع العقاد
الذي استقل به استقلال الكتاب الأصيل في عصر كثر فيه الأدعياء والمتطفلون.
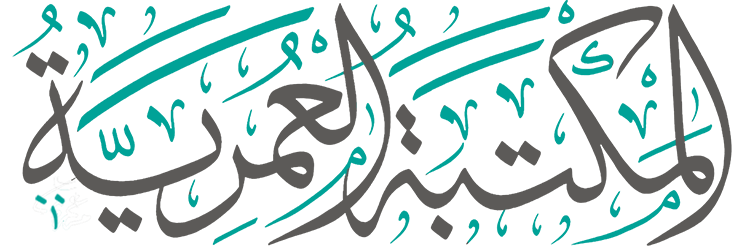


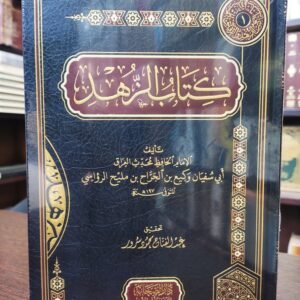
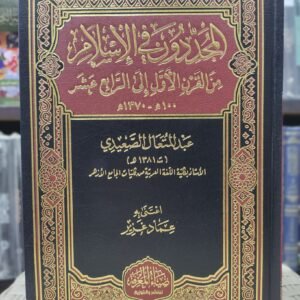
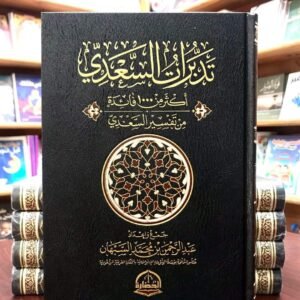
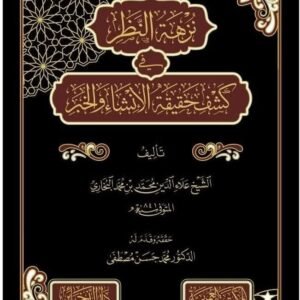





المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.