لقد ارتبط تاريخ معاهد العلم الإسلامية ارتباطًا وثيقًا بالتاريخِ الديني للإسلام.
كما ارتبطت نشأة هذه المعاهد بالتفاعل الذي جرى بين هذه الحركات الدينية؛ الفقهية منها والكلامية.
وهذا الكتاب
لا يقدِّمُ استعراضًا إجماليًا للتربية الإسلامية، بل يُحاول التركيز على مؤسَّسَة تعليمية بعينها،
وهي الكليَّة الإسلامية، خاصة في الشكل الذي اتخذته هذه الكليَّة،
وهو “المدرسة”. كما يُركِّزٌ على “طريقة النظر” التي كانت نتاجَ هذه المؤسَّسّةِ التعليمية.
وينصبُّ الاهتمام الأكبر في هذه الدراسة على القرنِ الرابع الهجري، الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي، في بغداد،
وهما يُمثِّلانِ الزمان والمكان اللذين ازدهرت فيهما المدرسة وطريقة النظر،
مع أنَّ نشأة كليهما تعودُ إلى القرن السابق لذلك. وذلك برغم ما يحفّلُ به الكتاب من إشاراتٍ فتراتٍ زمنيةأخرى غير تلك الفترة،
وأماكن أخرى غير بغداد.
والهدف من وراء ذلك هو
إثباتُ أن المدرسة التي تجسَّدت فيها العلوم الدينية الإسلامية في أكمل صورها وهي الفقه،
كما برز فيها الاتجاه الديني الأمثل في الإسلام، وهو الاتجاه السلفي
، وأنَّ الفقه والاتجاه السلفي تضافرا معًا لإحداثِ طريقة النظر أو الطريقة المدرسية،
التي كانت ابتكارًا فريدًا تميَّزت به العصور الوسطى.
جورج مقدسي George Makdisi:
وُلد مقدسي في ديترويت (ميشيغان) في عام 1920، لعائلة لبنانية هاجرت من لبنان إلى الولايات المتحدة قُبيل الحرب العالمية الأولى.
وعمل أستاذًا في جامعة مينيسوتا، كما عمل أستاذًا زائرًا في: كوليج دو فرانس Collège de France،
والسوربون بباريس IV-Sorbonne. ومنحته جامعة جورج تاون George Town الدكتوراه الفخرية ت
قديرًا لجهوده في مجال الدراسات الإسلامية.
وفي عام 1993 نال مقدسي جائزة جورجيو ليفي ديلا فيدا للتميز Giorgio Levi Della Vida Award for Excellence.
واستقر مقدسي في ولاية بنسلفانيا، وعمل أستاذًا في جامعتها حتى تقاعد عام 1990،
ثم ما لبث أن توفي في السادس من سبتمبر 2002 في هدوء في منزله الكائن بولاية بنسلفانيا عن عمر ناهز 83 عامًا.
كان مقدسي علَّامةً غزير الإنتاج، وقد تُرجم عدد من آثاره إلى العربية،
نخص بالذكر منها: “نشأة الكليَّات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب”،
“ابن عَقيل: الدِّين والثقافة في الإسلام الكلاسيكي”،
“الإسلام الحنبلي”، “خطط بغداد في القرن الخامس الهجري”، وغيرها.
كما خلَّف مقدسي عشرات المقالات التي تركزت حول الفكر الإسلامي والفقه والتاريخ،
ولا سيما تاريخ التعليم في الإسلام والغرب من منظور مقارن.
كتب ش .رسلان
عن الكتاب : في البداية لم أكن أعلم محتوى الكتاب بشكل كامل ثم بدأت أتعرف عليه في أثناء القراءة
فهو يتحدث عن نشأة مدارس التعليم ويتخذ القرن الرابع الهجري وبغداد –
فتلك الفترة تمثل مرحلة ازدهار المدرسة وطريقة النظر خاصةً في بغداد – محاولاً إيجاد علاقة بين
الحركة العلمية التي نشأت في الشرق وبين نظيرتها التي ظهرت في الغرب بعدها بما يقارب القرن من الزمان
فخلافاً لغيره ممن سبقه من المستشرقين،
يرى المقدسي وجود علاقة قوية بين النهضة الأوربية ومعاهد العلم عند المسلمين؛
ولكنه لا يرى أن مجرد التعاقب الزمني دليل كافي على وجود تلك العلاقة!،
وإنما العلاقة الحقيقة تظهر في “وجود نظائر وتشابة وتطابق في المسارات والاتجاهات”
المستخدمة في طريقة التدريس ” فإنه لا يمكن منطقياً أن تكون كلها مجرد متشابهات،
فعندما نجد المصطلحات الفنية المستعملة في الثقافتين تتطابق في حالات كثيرة في معانيها ليس من ناحية الشكل فقط،
بل التتطابق في وظيفتها أيضاً، فإن هذا لا يمكن اعتباره وليد المصادفة!! “
الترجمة: جيدة، وتنسيق الكتاب أيضاً جيد وإن كان في بعض الأخطاء المطبعة لكنها ضئيلة جدا
أما عن تقسيم الكتاب:
(1) الفصل الأول
تحدث فيه عن المذاهب الفقهية بشكل موجز؛ وعن تطور المعاهد العلمية من المسجد إلى المدرسة؛
والوقف – بشئ من التفصيل- ودورة في نشأت تلك المدارس والمعاهد وتحديده لنوعية المواد التي تدرس ودور القائمين عليه وطبيعة عملهم..
(2) الفصل الثاني :
يتحدث عن المواد الدراسية داخل تلك المعاهد وكيفية اختيارها؛ وتقسيم العلوم نفسها بحكم تدرسيها إلى علوم شرعية وعلوم مساعدة
وهذا هو النوع الذيذ”كان مقبولاً من عامة المسلمين ويدعمه “
وأما النوع الثاني فهو علوم الأوائل أو العبوم الفلسفية” فهو غير منهجي كان يُدرس سراً في المنازل أو دور العلم “
ولم يكن هناك التزام بمنهج معين او نمط معين” حيث كانت تتمتع المعاهد في ذلك الوقت بحرية الإختيار بين المناهج وطرق التدريس “
(3) الفصل الثالث :
يتناول صورة المدرسين والطلاب درجاتهم التعليمية وكيفية التعامل بينهم ومستويات الطلاب في المدارس
وكيف كانت توزع عليهم غلة الوقف وكم يستحق كل منهم من تلك الأموال
(4) الفصل الرابع :
يُعرف فيه كيفة نشأت معاهد العلم في أوروبا وكيف أثرت فيها الطريقة الإسلامية
وعن أسس الكليات ومصادر تمويلها وقوانين الدراسة فيها
ومن المتحكم في تعيين المدرسين أو إعطاء “إجازة التدريس” وعن المواد الدراسية بها.
و بناءً على المقدمات السابق ذكرها
تأتي الخاتمة والملاحق :
يبين في الخاتمة عن طريق المقارنة بين النظامين أوجه التشابه الحقيقية لما أسسه في الفصول السابقة ،
ففي نظري هي أفضل ما في الكتاب،
ثم ينتقل إلى الملاحق فيرد فيها على من ادعى “عدم وجود علاقة بين المدارس والكليات الإسلامي
وبين النهضة الأوروبية” من الكتاب السائقين له..
يعرض الطريقة التي توصل بها غيره لعدم وجود تلك العلاقة أو لقلة تأثيرها إن هو أثبتها ثم ينقد تلك الطريقة
ويبين ما يراه صواب منها أو خطأ.
كتب سقراط جاسم
يعتقد جورج مقدسي، المستشرق الشهير، أنه من الضروري فهم الفرق بين مفهوم الكلية والجامعة في المؤسسات التعليمية الإسلامية.
يشير مقدسي إلى أن
المفهوم الأول
يشير إلى مؤسسة تعليمية تركز على تدريس الفروع الأساسية للمعرفة،
بينما يشير المفهوم الثاني
إلى مؤسسة تعليمية تركز على تدريس العلوم المتقدمة والبحوث العلمية.
ويؤكد مقدسي على أهمية فهم هذا التمييز لفهم التطور التاريخي للتعليم في العالم الإسلامي.
.
فالكلية هي مؤسسة تنشأ عادةً من مبادرة شخصية وقفية، بينما تنبع الجامعة من هيئة مُرسَّمة تتمتع بحقوق وامتيازات مختلفة.
ويرى مقدسي أن النظام الجامعي الإسلامي لم يعرف مفهوم الجامعة كهيئة مرسومة،
ولذلك يفضل استخدام مفهوم الكلية بدلاً من الجامعة. وسيوضح مقدسي هذا الأمر بشكل أكثر تفصيلاً في الفصل الأخير من كتابه.
.
يبدأ مقدسي دراسته حول تاريخ التعليم في الإسلام بتحليل نشأة المذاهب الفقهية الإسلامية وتطورها،
والعلاقة الحميمة التي تربط المذاهب بمؤسسة المدرسة.
ومع أن المدرسة لم تكن النمط الوحيد لأنظمة التعليم الإسلامية، إذ سبقتها أنماط أخرى مثل حلقة المسجد،
فقد شكلت المدرسة تطورًا نوعيًا ومميزًا في مفهوم التعليم وهدفه ومناخه وأدواته.
وبما أن المدرسة لم تكن ممكنة بدون الوقف،
فإن مقدسي يعرض دراسة مهمة حول نظام الوقف وشروطه وأهدافه، وعلاقته بالضمير الإسلامي.
.
وفي الفصل الثاني
من الكتاب، يناقش مقدسي أنواع المعرفة في الثقافة الإسلامية ويعرض تنظيم العملية التعليمية وطريقتها.
ويخصص مقدسي مساحة كبيرة لسرد السيرة التعليمية لعدد من العلماء المسلمين،
ويتحدث عن الطريقة المدرسية والجدل والمناظرة والتقرير التعليقة، وهي من أعلى مستويات التعليم الإسلامي.
وفي الفصل الثالث،
يشرح مقدسي تفاصيل الجماعة المدرسية، بما في ذلك المدرسين والطلاب والمواقع والمهام والوظائف.
وفي الفصل الأخير،
يقارن مقدسي نشأة التعليم الإسلامي بالتعليم الغربي المسيحي في أوروبا الوسطى.
.
باختصار، ي
قدم مقدسي في دراسته تحليلاً شاملاً لتاريخ التعليم في الإسلام،
ويستعرض أنواع المعرفة ونظام العملية التعليمية والمدرسة والوقف والجماعة المدرسية.
ويختتم دراسته بمقارنة نشأة التعليم الإسلامي بالتعليم الغربي في أوروبا الوسطى.
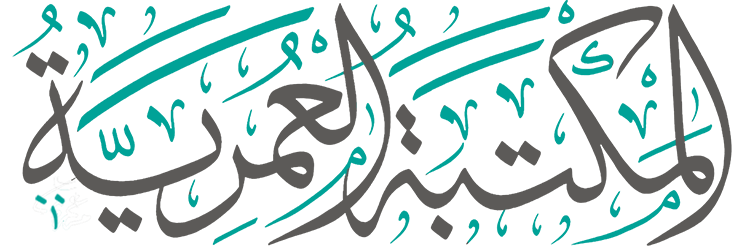

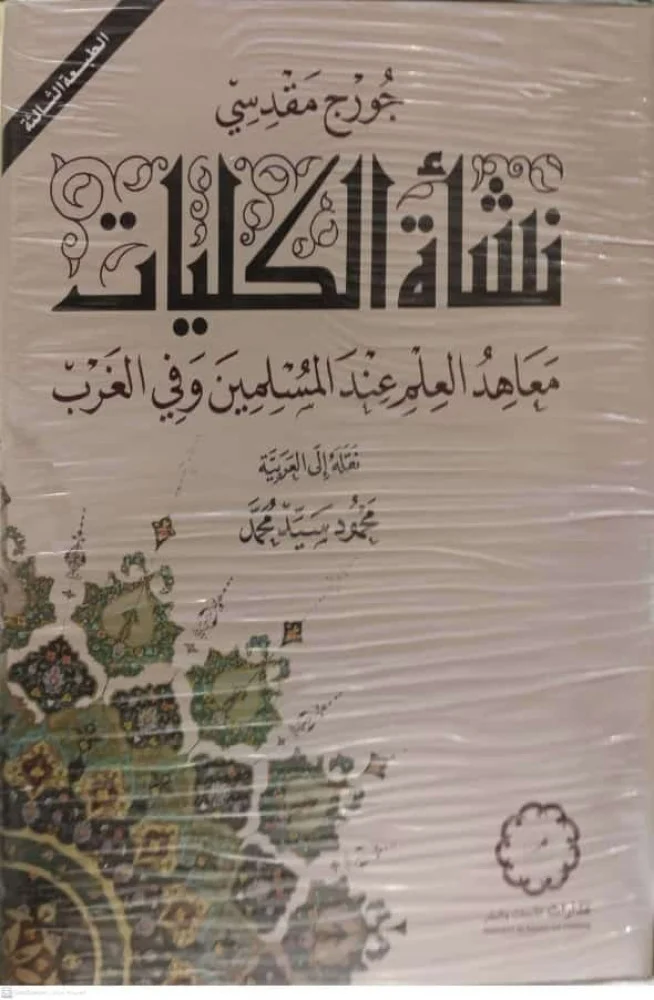
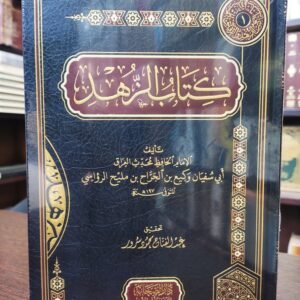
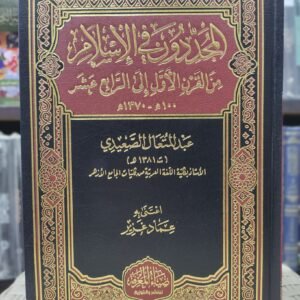
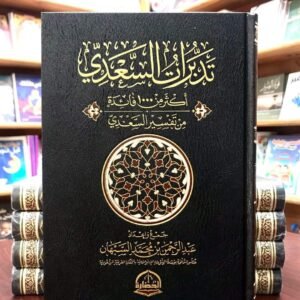
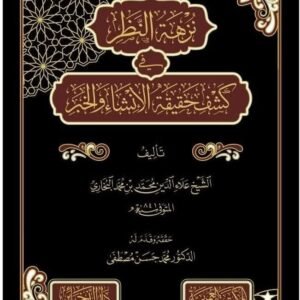





المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.