جمهرة المقالات.. عباس العقاد { 5}
للأستاذ : عباس محمود العقاد،
جمعها وقابلها على أصولها: د. عبد الرازق عيسى
راجعها ودققها: د. أحمد رجب حجازي
وعنوانه: «في رحاب الأدب والنقد (3)
وهو عنوانٌ مُشعر بالصلة الواشجة بينه وبين المجلدين السابقين عليه؛
إذ جاءا موسومين بالعنوان نفسه، على اختلاف الترتيب.
ومردُّ هذه الصلة إلى تشابه القضايا وتجانس الموضوعات
التي تناولها الأستاذُ العقاد في المقالات التي اشتملت عليها ثلاثةُ هذه المجلدات.
لقد عالج الأستاذ في مقالات هذا المجلد
طائفة من الموضوعات المتنوعة التي يمكن تصنيفُها تحت جملة من المحاور المُنبئة عن موسوعية الكاتب القدير،
وإحاطته المُعجِزة بمباحث اللغة والأدب والفكر والدِّين والفلسفة والتاريخ
وما إلى ذلك مما ترك فيه الأستاذ من بديع الآثار ما ملأ به سمع الزمان وشغل ألسنة الناس.
فمن مسائل اللغة التي عرض لها الأستاذُ بالدرس والمناقشة،
وكانت له فيها آراءٌ مبتكرةٌ جديرة بأن يتوقف القراءُ والباحثون أمامها مليًّا
مسألة «السليقة اللغوية»،
ومسألة العلاقة بين «الفصحى والعامِّية».
ولقد انتهى الأستاذُ -في خصوص هذه المسألة الأخيرة-
إلى رأي جامع يقوم على حتمية التجاور بين اللغتين؛
فقرر أنه من المستبعد أن يأتي على الناس زمانٌ تصبح فيه لكل أمة لهجةٌ واحدةٌ من لغتها،
يتكلم بها عليتُها وسَوَادُها، ويكتب بها أدباؤها ويتحدَّث سُوقَتُها،
وإنما ستبقى اللغة الفصحى واللغة العامِّية على مدى الزمان؛ إذ لكل لغة منهما مزيتُها ومقامُ استخدامها.
ومن المقالات التي تندرج تحت مبحث اللغة أيضًا
مقالتُه عن «الحروف اللاتينية»،
وقد بسط فيها خلاصة رأيه فيما اقترحه عبد العزيز باشا فهمي على مجمع اللغة العربية من اقتباس الحروف اللاتينية؛
لتيسير الكتابة العربية؛ فخالفه كثيرون، وكان العقادُ على رأس مخالفيه؛
لأن هذا المقترح -على حد تعبيره- يترك الصعوبة الأصيلة قائمةً،
ويُعنَى بالصعوبة المتفرِّعة عليها، وهي تابعةٌ لها باقيةٌ ببقائها.
وينتظم هذا المجلدُ عدة مقالاتٍ عقدها الأستاذ للحديث عن بعض قضايا الأدب والنقد؛
كمقالته «معالم الأدب المصري الحديث»
التي رام فيها تقديمَ صورة مجملة لحالة الأدب في مصر منذ مطالع القرن التاسع عشر الميلادي إلى زمانه؛
ومقالته «أثر الحرب في الأدب العربي»
التي يقارن فيها بين أثر الحربين العالميتين الأولى والثانية في الأدب العربي،
ومقالته «النقَّاد والجمهور: أيهما الحَكَم في الآداب والفنون؟»
التي فرَّق فيها تفريقًا دقيقًا بين قراءة الجمهور وقراءة النقَّاد للأعمال الأدبية والفنية،
ومقالته «هل يصبح لنا أدب عالمي؟»
التي يقرِّر فيها أن الأدب المصري صالحٌ للذيوع في لغات العالم لو تيسَّرت له وسائلُ الذيوع،
ويصحِّح خطأً شاع بين الأدباء،
وهو أن الأدب العالمي لا بد أن يكون أرقى من الأدب القومي المحصور في أمة واحدة،
فالصحيحُ أن كل أدبٍ ذاع في أنحاء العالم إنما كان قبل ذلك مقصورًا على البلد الذي نشأ فيه،
فإذا كانت له مزِية نفيسة فهذه المزِية مستقرةٌ فيه ملازمةٌ له،
وليست هي بالمزِية التي تطرأ عليه عندما يُترجَم ويُنقَل بالترجمة إلى لغات كثيرة.
ومن مقالات هذا المجلد أيضًا
ما جاء عرضًا لبعض الكتب الممتازة في بابها، المشهود لمؤلِّفيها بالإجادة والإتقان.
وقد جرى الأستاذُ في عرضها على مألوف طريقته شرحًا لأفكارها وبيانًا لمنهجها وانتقادًا
لمواضع النقص فيها على نحو لا شبهة فيه لمجاملة أو انحياز.
فمن ذلك مثلًا
مقالةُ «تقريظ الكاتب الكبير»
التي عرض فيها لكتاب «الوحي المحمدي» للشيخ محمد رشيد رضا،
الذي أثنى عليه العقادُ فأطال الثناء،
وجعل يسرد فضائله في الإحاطة بمسائل الفقه والشريعة، والبراءة من الجمود والتعصب،
مع سمو الأخلاق ونبل المقاصد، واستجماع الشروط الضرورية لممارسة الاجتهاد والتفكير المستقل.
ومع ذلك، فقد أخذ العقادُ على الشيخ رشيد في هذا الكتاب
قلة البَصَر بأصول المنطق النفسي أو منطق الدراسات النفسية الذي هو وحده عدة البحث في جميع الحقائق العالية،
دون المَنطق الدارج المألوف في المناقشات اليومية والوقائع الصغيرة.
وعلى الرغم من موضوعية هذا النقد وبراءته من الهوى،
وعلى الرغم من ثناء العقاد على الكتاب في الجملة، وإشادته بمزاياه ومواطن الإجادة فيه،
فقد غضب الشيخ رشيد رضا
غضبًا بدت آثاره جليةً في ذلك المقال الذي نشره في المنار؛
فبدلًا من أن يفنِّد رأي العقاد، ويرد عليه ردًّا هادئًا يُلزمه فيه الحُجَّة،
جعل يطعن في معرفته بالدين،
ويرميه بقلة الاطلاع على المباحث الدينية، شأن أضرابه ممن تعلَّموا في المدارس العصرية،
ويتهمه بممارسة النقد على غير بصيرةٍ من الرأي؛ لأنه لم يقرأ الكتاب كله،
ولو قد قرأه قراءةَ دقةٍ وتأملٍ لكان حُكمه عليه أصحَّ مما كتبه، أو لَمَا انتقص مؤلِّفَه بغير عِلمٍ…
إلى غير ذلك من اتهامات ما كان أغناه عن حشدها في مثل هذا المقام الذي خرج فيه عن حدِّ الردِّ الواجب على النقد
ومناقشة الرأي المخالف إلى مجرد الرغبة في الانتصار للنفس والتشنيع على الخصم ورميه بكل نقيصة
يُعاب بها الكُتَّاب والمفكرون.
ولدينا في هذا الباب أيضًا
مقالة «النيل: حياة نهر عظيم»
التي عرَّف فيها الأستاذ العقاد
بكتاب النيل لمؤلِّفه إميل لدفيج، الكاتب القدير
الذي اشتُهر بمؤلَّفاته التي يؤرِّخ فيها لسِيَر العظماء كأنها أنهار تفيض من النبع إلى النهاية،
فأراد أن يكتب حياة النيل كأنه إنسانٌ يتقدَّم من مولده إلى أقصى مداه.
ومقالةُ «على هامش السيرة»
التي أثنى فيها على كتاب الدكتور طه حسين فأطال الثناء
حتى ليُخيَّل إليك أن هذه المقالة أقربُ إلى التقريظ منها إلى العرض النقدي لكتاب العميد؛
فكان مما ذكره في معرض التقدير والإشادة أن أي قارئ مستنير يطلع على هامش السيرة حق الاطلاع
يستطيع أن يعرف المقدمات والبشائر التي هَيَّأت البيئة لظهور النبي وظهور الإسلام.
وهناك كذلك مقالة بعنوان
«رجال المال والأعمال»
عرض فيها العقادُ لكتابٍ بهذا العنوان أصدرته المقتطف،
تريد بإصداره أن تستدرك ما اعترى بابَ السير والتراجم في العربية من نقص؛
حين قصرها أصحابُها على الفُقهاء والشُّعراء والأدباء والأمراء والنُّحاة ومن إليهم.
وإنما وجهت المقتطف عنايتها إلى تراجم رجال الأعمال؛ لأنهم –كما يذكر العقاد- عنصرٌ قوي في حياة الأمم،
ومعرض مزدحم بصنوف الدراسة النفسية والاجتماعية،
ولهم من الحق في التاريخ مثل ما يحق لجميع النابهين من رجال الأدب والحرب والسياسة.
على أن هذا المجلد لم يَخلُ من
عدة مقالات وقفها الأستاذُ العقاد على الحديث عن ن
فر من أعلام الأدباء والمفكرين والفنانين ورجال السياسة.
ومن المعلوم أن العقاد كان ولوعًا بكتب السير والتراجم،
وكان يعتقد أنها من أنفع الكتب وأمتعها، وأحقها بالدرس والتداول.
ومن أمثلة مقالاته في هذا الباب
ثلاثة المقالات التي أفردها لتوماس هاردي الشاعر والأديب والروائي الإنجليزي،
الذي وصفه بأنه أديب الإنجليز الفرد في زمانه،
ومقالته عن بيتر بول روبنس المصوِّر والسياسي الألماني،
ومقالته عن هنريك إبسن الروائي المسرحي النرويجي، ورائد المدرسة الاجتماعية بين كُتَّاب المسرحيات،
ومقالته عن ماكيافيلي وكتابه «الأمير».
وهناك سوى ما تقدَّم مقالاتٌ أخرى في مباحث متفرقة من الفكر والفلسفة والأدب؛
كمقالة «مقاييس الكمال بين الماضي والمستقبل»،
ومقالة «حرية الفكر» التي يعدُّها شرطًا لازمًا لحرية الحياة،
ومقالة «مصير الحضارة»
في ظل ما اجتمع اليوم في مصانع العالم ومخازنه من أسلحة الحرب وأدوات الهلاك ووسائل التدمير
ما لم يجتمع مثله قَطُّ في تاريخ الإنسان،
ومقالة «الفن بين الصدق والكذب»،
ومقالة «أريحية الأمم»،
ومقالة «النقائض» التي ذهب فيها إلى أن كثيرًا من نقائض الأخلاق ليس بنقائض،
ولاسيما في أخلاق العظماء،
وإنما يبدو لنا كذلك؛ لأننا نخلط بين الباعث والأثر، أو ننظر إليه من وجهةٍ غير وجهته فنفهمه على معنى غير معناه.
ومن أنفَس هذه المتفرقات وأحفلها بالفوائد
تلك المقالة الموسومة بـ «في النقد التاريخي»
التي أرسى فيها قاعدةً مهمةً
في نقد الروايات والأسانيد التي يختلف المؤرخون ونَقَدَةُ الأخبار في تقديرها
بين قبول ورفض،
وبين ترجيح وتوهين.
وأما القاعدة التي قررها الأستاذ العقاد فهي
وجوب التمييز بين صحة الرواية ودلالة الرواية،
وهما شيئان مُختلفان؛
لأن الرواية الصحيحة قد تكون خِلْوًا من الدلالة في تاريخ الأمة أو سيرة العظيم،
وقد تكون الرواية الكاذبة أدلَّ على الأمة أو على العظيم من كل خبر صحيح.
ولهذا لا يصح أن يكون عمل الناقد التاريخي مقصورًا على إثبات الصحيح وإسقاط غير الصحيح؛
لأن الخبر الذي له دلالة نفسية أو دلالة اجتماعية لا يسقط من سجل التاريخ،
وإن كان مقطوعًا بكذبه أو مشكوكًا فيه، فإنما المهم -جِد المهم- في التاريخ هو ما يدل عليه.
وبعدُ، فهذه مجرد شواهد ممثِّلة ونماذج دالة على تنوع مقالات هذا المجلد وشدة ثرائها.
وقد نهج الأستاذ العقاد في تناولها منهجه الذي عُرف به،
فأنت واجدٌ في هذه المقالات ما تجده في سائر أعماله
من ثقوب الفهم وسعة الاطلاع وإحاطة العلم وأصالة الرأي وجرأة النقد وقوة البرهان،
وكلُّ أولئك مزايا أصيلةٌ فيه لا يزيدك الإمعان في قراءة تراثه الخصب
الذي تجلت فيه إلا إكبارًا له وتقديرًا لعبقريته.
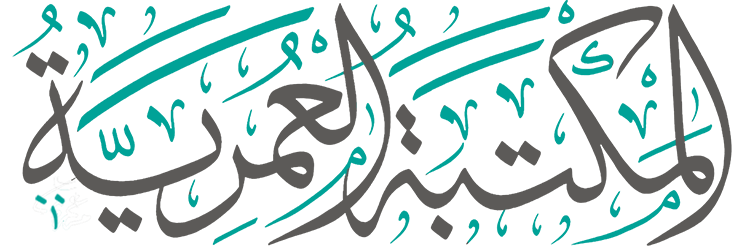

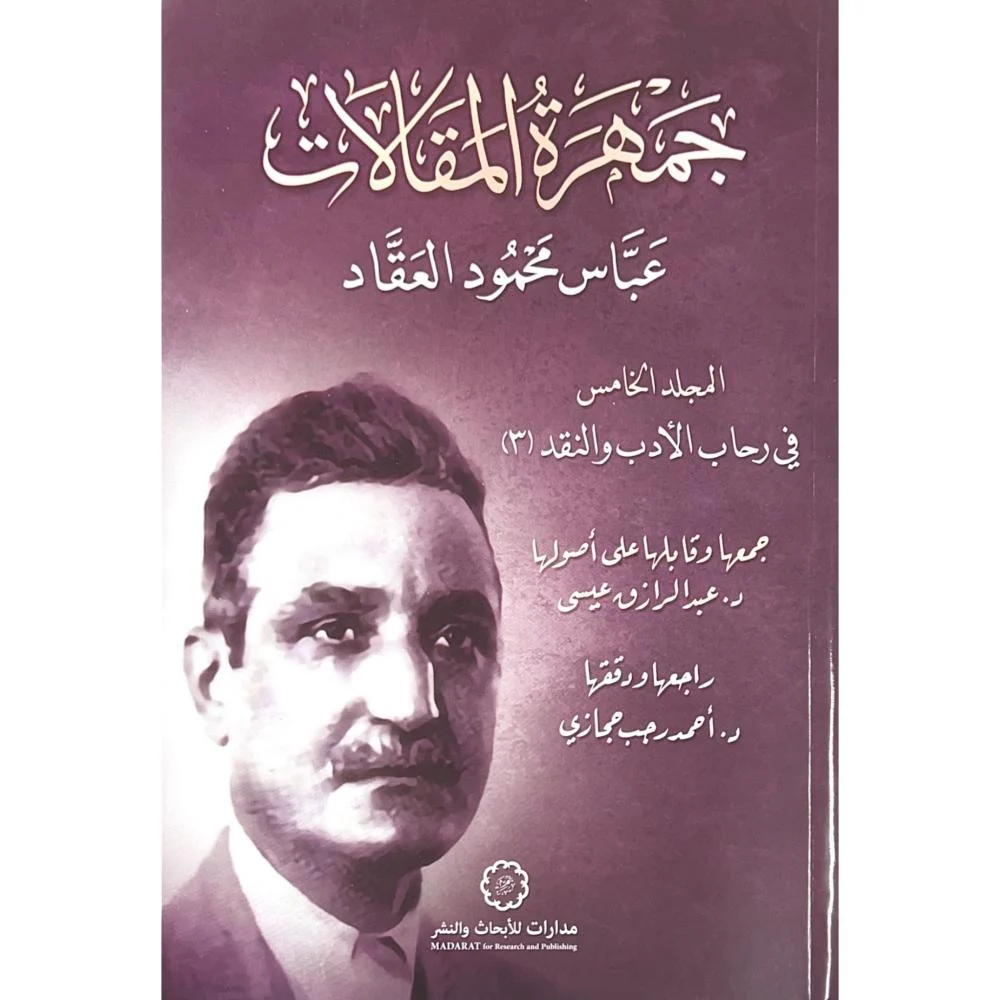
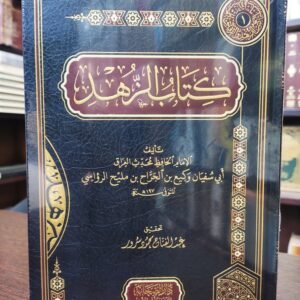
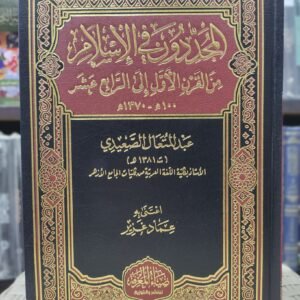
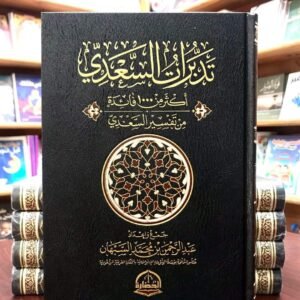
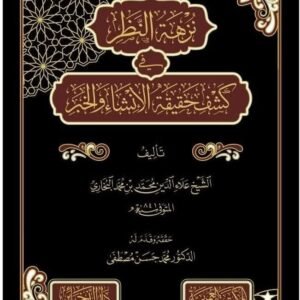





المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.