جمهرة المقالات (4)
للأستاذ عباس محمود العقاد،
وهو بعنوان: «في رحاب الأدب والنقد (٢)
جمعها وقابلها على أصولها: د. عبد الرازق عيسى
راجعها ودققها: د. أحمد رجب حجازي
وفيما يلي «كلمة الناشر» في التعريف بالمقالات التي انتظمها هذا المجلد:
«هذا هو المجلد الرابع من جمهرة المقالات
ويَضُم طائفةً من المقالات المتنوعة التي نُشر أكثرها في مجلة «البلاغ الأسبوعي»،
حين اتسع فيها المجالُ للكتابة الأدبية، وللتأليف في الموضوعات التي ليست من قبيل ما يُنشر في الصحف اليومية.
وتعتبر امتدادًا لمقالات المجلد الثالث التي يشملها عنوان جامع هو «في رحاب الأدب والنقد».
وأكثرُ مقالاتِ هذا المجلد حديثٌ عن الكتب والمؤلَّفات التي قرأها الأستاذ العقاد؛
تعريفًا بأصحابها، وعرضًا لمحتوياتها، وتحليلًا لأفكارها، على وفاق الطريقة النقدية المعهودة التي يعرفها قراءُ الأستاذ،
ولعلهم لا ينكرونها عليه؛ لما فيها من جرأة في الإفصاح عن الرأي، وصرامة لا تعرف المجاملة أو المحاباة.
وربما قصد الأستاذ إلى الحديث عن هذه الكتب أو المؤلَّفات ابتداءً، على نحو ما تدلنا عليه عناوينُ المقالات نفسِهَا؛
مثل: «إعجاز القرآن» للأستاذ مصطفى صادق الرافعي،
و«حديث عيسى بن هشام» لمحمد المويلحي،
و«تاريخ المسيح» لإميل لدفج،
وربما جرَّه إلى استعراضها ومناقشة ما اشتملت عليه من صحيح الرأي أو باطله تناولُه لمسألة تمتُّ لهذه الكتب
بوجه من وجوه الصلة من مسائل الأدب أو الفن أو التاريخ؛
كحديثه -مثلًا- عن كتاب «الوطنية والأممية» للمؤرخ الإنجليزي رامزي موير،
في سياق مناقشته للفكرة الوطنية.
وموير هذا هو أستاذ التَّارِيخ الحَديث في جامعة مانشستر،
وقد وصفه العقاد بأنه «عالمٌ مؤرخٌ، ولكنه مبشِّرٌ إنجليزيٌّ يُسخِّر العلم والتاريخ في خدمة الدولة البريطانية».
على أن هذه النقيصة التي شانت عمل هذا المؤرخ لم تمنع العقاد من الرجوع إليه؛
لأنه حين يبحث في معاني الوطنية وتعريفاتها
«يتكلَّم كلام العالم المحقق،
لولا أنه اتَّخذ له وجهةً غير وجهة العالم من مَبدأ الأمر، فلم يَتأد به البَحث إلى النتيجة البريئة مِن الأهواء».
ومن الكتب التي عرض لها العقادُ أيضًا في سياق مناقشته لبعض الأفكار والمفاهيم
كتاب «الضحك» لبرجسون
الذي تكلم عنه في معرض حديثه عن فلسفة الضحك،
وبعض مؤلفات بودلير
التي جره إلى الحديث عنها معالجته لقضية الجمال والشر في الفنون.
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن الكتب
كان بابًا مألوفًا من أبواب الكتابة في الصحف السيَّارة والدوريات الأدبية لهذا العصر،
وقلَّ أن تجد كاتبًا من كُتَّاب هذا الجيل لم يجعل لمثل هذا الحديث نصيبًا معلومًا من عنايته،
قلَّ هذا النصيبُ أو كَثُرَ.
وقد أرضى العقادُ بنقده نفرًا من الكُتَّاب والأدباء، وأسخط آخرين،
ولعل مَن أسخطهم نقدُه كانوا أكثر ممن أرضاهم؛
فطفقوا يردوُن عليه ويفنِّدون كلامه، ويقابلون عنفه في النقد بعنفٍ في الرد.
وكانت هذه الردود والمساجلات
فصلًا مهمًّا وشائقًا من فصول تاريخنا الفكري والثقافي خلال النصف الأول من القرن العشرين،
وهي الحقبة التي كانت فيها المعاركُ الأدبيةُ سمةً لازمة من سماتها.
ولئن اشتجر الخلافُ بين شيعة العقاد وشيعة خصومه حول النتيجة الأخيرة التي آلت إليها هذه المعاركُ الأدبية اللاهبة،
من حيث الغلبة والانتصار،
أو السقوط والاندحار،
فإن الحقيقة المؤكدة هي
أن القارئ العربي قد أصاب زادًا أدبيًّا وفكريًّا خصبًا لا عبرة فيها بانتصار هذا الطرف أو ذاك.
وهكذا، نقد الأستاذ العقاد كتاب «إعجاز القرآن» للرافعي، فغلا في النقد،
حتى لقد أخرجه من دائرة الكتب الجديرة بأن تحمل هذا العنوان،
وأخرج صاحبَهُ من زمرة الكُتَّاب المجيدين في هذه المسألة؛
إذ الكتابُ في نظر العقاد لا يعدو أن يكون «نُموذجًا في البلاغة البدويَّة، أو تَسبيحًا بالآيات القرآنية،
أو تحيةً يقرؤُها المُسلم فيرتاح إليها،
ويقرؤها غيرُ المسلم فلا تَزِيده بالقرآن عِلمًا، ولا تَطرُق من قلبه أو عقله مكان الإيمان والتسليم،
ولكن لا يَقُل عنه: إنه كتابٌ في إِعجاز القرآن، وليسَ فِيه شاهدٌ واحدٌ على مُعجزات الكلام،
ولا هُو نَهَجَ فيه ذلك المَنهج الذي أحسن فيه الجُرجَاني أيما إحسانٍ،
وأفاد به الآداب العربية أيما إفادةٍ،
فإنما الثَّناء على القرآن في كتابٍ تُناهز صفَحَاته الأربعمائة حسنةٌ طيبةٌ يُكتب للرافعي أجرُهَا وثوابُها عِند الله،
ولكنَّها لا تُكتب له في سِجِل المَباحث والعلوم، ولا تُعد من حسنات التفكير والاستقراء».
وكذلك كان للأب أنستاس ماري الكرملي
نصيبٌ موفورٌ من هذا النقد العنيف؛ حيث استخفَّ العقادُ بمنزلته في تذوق الأدب،
وطعن في معرفته بالعربية، وبصره بمعاني الشعر.
وقد مزج العقادُ هذا النقد بشيء غير قليل من السخرية والاستهزاء،
فوصف الأب أنستاس بأنه
«راهبٌ أدمن الاشتغال باللغة العربية حتى تَرَيبّ رؤساؤه به لهذا،
فنفَوه إلى ديرٍ ينقطع فيه عن خدمة هذه اللغة زمنًا لا أدري ما قدره،
فإن صح ما رواه صاحبي الأديب فهم قد أطلقوه الآن؛ لأنهم رَجَعوا إلى الصَّواب في أَمره،
وعرَفوا أن البَلِيَّة على اللغَُة العربية في اشتِغَاله بها لا في انصِرَافه عنها وتركِهَا وشَأنها».
وقد قابل أنستاس عنف العقاد بعنف مقابل لا يقل عنه ضراوةً؛
فقال فيه: «وقد اشتُهِر العقاد بالدَّجل السِّياسي في كتابته،
وهو عَين ما يَتبَعه الآن في أدبه الذي لا يُمَثِّل الجديد منه إلا ما يَنهَبُه من الأدب الأوروبي بعد شيءٍ من التحوير والسَّفسطة»
ولم يتورَّع أنستاس في هذه الخصومة
عن سوق السباب البذيء الذي وجهته جريدة السياسة (المُؤَرخة في ٣٠ أغسطس سنة ١٩٢٨) إلى العقاد،
إذ وصفته بأنه «رجلٌ وقِحٌ سليط اللسان،
كُلُ تاريخه منحصرٌ في الإساءة لكُلِّ من أَحسَن إليه يومًا من الأيام.
هذا السَّليط اللسان لا يَستحي أن يتبجَّح بالكرامة والإباء وعِزَّة النَّفس، وأنه لَم يُطأطِئ رأسه لمخلوقٍ!
ويعلم الله والناس ويَشهَد تاريخُه الماضي كم طأطأ الرَّأس حتى لمس الأرض إرضاءً لسيدٍ كان يَشتَغل عِنده،
وكان لمؤلفات الكُتَّاب والمؤرخين والأدباء الأوربيين
حظٌ غير قليل من عناية الأستاذ العقاد في المقالات التي ضمها هذا المجلد؛
فقد تحدَّث عن
كتاب «تاريخ المسيح» لإميل لدفج
حديثًا مستفيضًا في خمس مقالات متتابعات، ولم تمنعه مكانةُ إميل في فن التراجم والسِّيَر من نقده نقدًا موضوعيًّا هادئًا؛
فقال مثلا: «كان إميل لدفج الذي أَشَرنا إلى تراجمه للعظماء في المَقال السابق موفَّقًا في تَرجمته لنابليون وبسمارك،
وأقل مِن ذَلك توفيقًا فيما ظَهَر من ترجمته للشاعر جيتي باللغة الإنجليزية،
ولكنه لم يُصِب توفيقًا يُذكَر في ترجمته لڤيلهلم الثاني، ولا في ترجمته للسيد المسيح».
وكتب العقادُ أيضًا عن
شكسبير وعبقريته المسرحية،
وكيف «كان يخلُق الشُخوص ويحيا حياتها من الداخل، ويَجيئنا بها لِنراها كما نرى الأَحياء في هذه الدنيا،
ونَأخُذ أخبارها من أقوالها وأفعالها كما نأخذها من وقائع الأيام وامتزاج الناس بالناس».
وتوقف مليًّا أمام «هاملت»،
وذهب إلى أن في شخصيته «دِلالاتٍ كثيرةً على شكسبير،
بل لَم يَضع شكسبير على لِسان أحدٍ مِن أَبطاله بقدر ما وَضَع مِن كلامه هو على لِسَان هَاملت،
فشَكوى هاملت هي شَكوى شكسبير نفسه من النَّاس والحَياة ومن أبناء وطنه».
وينتظم هذا المجلد -فوق ما تقدَّم- طائفةً من المقالات التي تناول فيها العقاد بعض المفاهيم والقيم في الأدب والحياة والفن؛
فتكلم عن فلسفة الجمال والحب، وعن الصلة بين الجمال والشر في الفنون،
وهل في الشر جمال يصلح موضوعًا للفن، وعن الموسيقى والتربية الموسيقية،
وعن فن التصوير ومذاهبه بين القديم والحديث،
وعن سلطان العادة على نفوس البشر،
وعن الحب والغزل، وعن البطولة، والاعتراف بالعيوب
إلى غير ذلك من موضوعات نرجو أن يجد فيها القراءُ لذةً ومتاعًا».
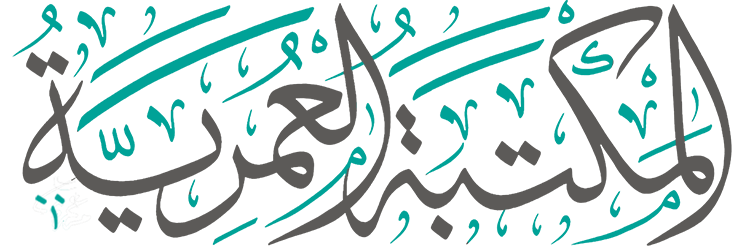

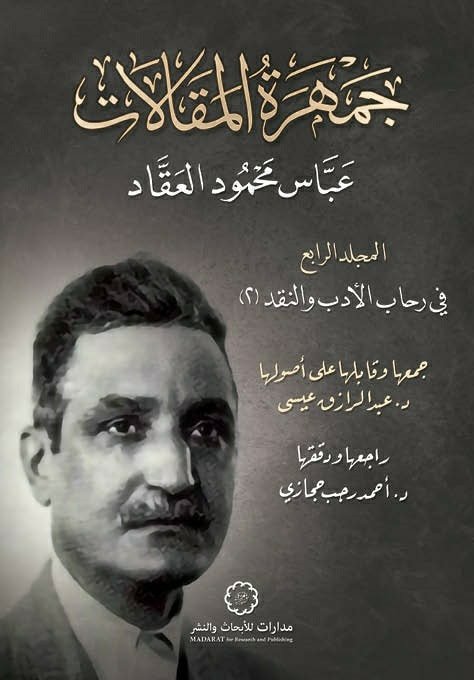
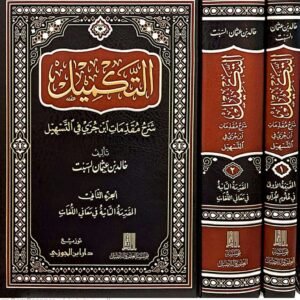








المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.